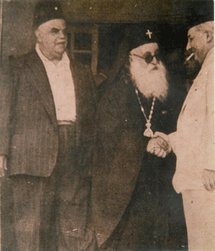
رياض الصلح
الى جميع من قتلوا او اغتيلوا وذهبوا غَفلَاً في لبنان:
كباراً وصغاراً، نساء ورجالاً، ان بسبب الحرب الاهلية او بسبب مختلف الحروب الكبيرة والصغيرة، المذهبية او العصبوية، العقائدية او الارهابية..... والذين يحتاجون إلى عمل مؤسساتي ضخم لكي يتم عمل أرشيف يضم اسماءهم وتواريخ استشهادهم مهما كان سبب القتل الذي وقعوا ضحية له..
إنه أقل ما يتوجب علينا تجاههم.
--------------------------------------
القتل رقابة في حدّها الأقصى
تُعَرَّف الرقابة على انها التضييق العشوائي او العقائدي على حرية التعبير عند كل فرد. وهي تحصل عبر تفحص الكتب والصحف والنشرات الاخبارية والمسرحيات او الافلام من قبل الممسك بالسلطة قبل السماح بإطلاع الجمهور عليها. وبمعنى أشمل، تعيّن الرقابة مختلف الاشكال التي تطال حرية التعبير، قبل نشرها أو بعده. ومنها الرقابة السياسية، عندما تضيّق الحكومة حرية التعبير. وتلك تكون رقابة مباشرة، أما الرقابة غير المباشرة او غير الرسمية، فتحصل بالطرق القمعية، خاصة عندما تكون وسائل الاعلام متمركزة في أيدي قلة مستأثرة وعبر أجهزة مخابراتية وأمنية مستحكمة. ناهيك عن ظاهرة الرقابة الذاتية وهي التي تنتج عن القمع والاضطهاد المستمرين وهي أقصى ما تطمح إليه الأنظمة القمعية لأنه يموّه حقيقة وجود رقابة ملموسة ومفضوحة. لكن الرقابة يمكنها ان تكون مؤسساتية او اجتماعية كما حصل مع اغتيال فرج فوده أو الاعتداء على نجيب محفوظ ونصر حامد ابو زيد.
وظاهرة الرقابة موجودة منذ القدم. فالرقيب وجد في روما القديمة ونظام الحسبة عرف ايام الخلافة الاسلامية. لكن مهمة المراقب في ذلك الوقت كانت الحفاظ على العادات أو منع الغش. وليس الرقابة كما نعرفها الآن.
مع ذلك حظيت الكتب بالرقابة على مرّ العصور. فأحرقت روائع وأعدمت أفكار وعُطّلت طاقات خلاقة...لكن يظل السؤال المثير: هل يجب أن تذهب الرقابة إلى أقصاها بحيث تصل إلى إنزال الموت بإنسان من أجل كتاب؟؟ من أجل فكرة؟ من أجل رأي سياسي؟
سؤال الخصوصية
يحفل التاريخ بالكتب الممنوعة التي عرّضت مؤلفي تلك النصوص على مرّ العصور للسجن أوالنفي أو الموت. الموت حرقاً كان من نصيب Giordano bruno الذي اعتمد على نظرية كوبرنيك لكي يبرهن فلسفياً على لانهائية الكون واحتوائه على أعداد لا تحصى من العوالم الشبيهة بعالمنا.
واستتباعاً، إذا كان التعبير عن الرأي الآخر المختلف ومجرد المطالبة بالإصلاح أو بالتغيير السياسي السلمي مما يستحق القتل من أجله، فماذا يظل أمام المطالبين بهذا التغيير للقيام به؟ هل الرضوخ وتأبيد الحكام والأوضاع السائدة على ما هي عليه في نوع من القبول والتشجيع على أسوأ انواع الاستبداد والطغيان؟ أم التسابق في استخدام العنف والبطش بين المتعارضين من مطالبين بالاصلاح ومن ممسكين بزمام السلطة؟ وندخل عندها في دورات من العنف والثأر والثأر المضاد التي لا يوقفها سوى مزيد من العنف ومن الاستبداد والطغيان من قبل الحاكم الفرد أوالديكتاتوريات او من قبل عسكريين أو حزب أو ما شابه!! وهذا على كل حال ما طبع الأوضاع السياسية في المنطقة العربية منذ نشوء الدولة الوطنية الحديثة.
لقد استطاعت الانظمة الديموقراطية المعاصرة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وقف دورات العنف هذه عن طريق وضع دساتير وقوانين أدى احترامها الى ممارسات ووسائل تعبير سلمية تحفظ الحق بحرية الرأي ما سمح بتداول السلطة سلمياً. لكن بلادنا لم تنجح بعد في دخول هذه الدورة ولا يزال العنف والقمع والاستبداد مسيطراً على معظم الدول العربية.
تميز لبنان بحكم خصوصياته وتنوع مكوناته السكانية بنوع من حرية وديموقراطية. وبيروت التي استحقت ان تكون عاصمة عالمية للكتاب للعام 2009 لتمتعها بدور ثقافي مميز ورائد غطى جزءاً كبيراً من القرن العشرين. كانت قد بنته على مهل منذ القرن التاسع عشر. لكن لم يكن ممكناً حصول ذلك الدور الثقافي بمعزل عن الطلب الخارجي والعربي عليه. فأوضاع الحريات السائدة في العالم العربي الموسومة بطابع الاستبداد، جعل من بيروت ملجأً لكل من ذاق طعم الاضطهاد والقمع السائدين في بلده وضاق بهما. وبذلك اصبحت بيروت مركز الصحافة العربية توَزَّع صحفها في أنحاء العالم العربي. وصارت مجرد الاشارة في هذا العالم الى الصحافة والحريات الصحافية لا بد من أن يعني بيروت. وكل من أراد الوصول الى اوسع عدد من القراء العرب، عليه ان يضمن نشر رأيه في جريدة او مجلة صادرة في بيروت. ما جعل منها في ستينيات القرن الماضي محطة إلزامية للكثير من الأقلام العربية التي لمعت في فضاء الثقافة العربية وفي المهجر. وهذا يطال بالطبع ميادين الأدب والفن والطبع والنشر والترجمة والصحافة.
ذلك كله جعل من بيروت عاصمة الثقافة العربية الأساسية التي ساهمت في إطلاق نهضة ثقافية عربية ولو متفاوتة ومتعثرة في الكثير من الأحيان.
حرية مترسبة
لكن الحرية والتسامح اللذان تمتعت بهما بيروت، وساعد على السماح بهما تعدد الصحف وتنوعها بشكل أساسي، وذلك قبل ان تكبّلها حروبها الأهلية وعصبياتها المتفلتة، كانت بحد ذاتها ما يمكن أن نطلق عليه اسم "حرية مترسبة"، بمعنى انها موجودة بسبب غياب المنع والتغاضي وليس بسبب موقف واعٍ وإيجابي يسمح بتشريعات وقوانين توجد ضوابط واضحة وراسخة للمؤسسات المعنية على طريقة تنظيم الاعلام الانجليزي مثلاً، ما من شأنه حفظ الحقوق لأصحابها. انها إذن الظروف الخاصة واللحظة الراهنة التي تسمح بالتسامح والتغاضي. ويكفي أن يعترض رجل دين أو رجل سياسة أو أي فعالية ثقافية او اجتماعية على كتاب ما أو فيلم أو منتج فني لكي يضع الوزير المختص تحت الضغط ويصبح منعه ممكناً . والدليل على ذلك جميع أشكال المنع والقمع والرقابة التي طالت كتاباً ومخرجين وصحافيين ومغنين (فضلاً عن اعتقال البعض من هؤلاء الأخيرين) والتي ظلت تمارس بشكل متفاوت، حتى في حقبة الحرية الذهبية. وتماماً لأنها تخضع لنزوة رئيس او تسلط جهاز أمني او لمجرد مزاجية الرقيب وميوله، سواء السياسية او الدينية او الفكرية. خاصة أن هذه الرقابة جزء من جهاز أمني وليست جزءاً من المنظومة الثقافية وقيمها.
أمر الرقابة في لبنان لم يقف عند حد المنع والسجن بل تعداهما الى القتل اغتيالاً وفي غالب الأحيان لكتاب أو صحافيين أو ذوي رأي أو سياسيين أورجال دين: من نسيب المتني وكامل مروة الى سمير قصير وجبران تويني مرورا بغسان كنفاني وسليم اللوزي ورياض طه ومهدي عامل وحسين مروة والشيخ صبحي الصالح . وهو لم يبدأ بعد الاستقلال لكنه كان قد بدأ قبل ذلك مع الإعدامات التي نفذها جمال باشا الجزار في عامي 1915 و1916....
والجدير بالملاحظة أن الاغتيالات لم تظهر إلا بعد أن حصل لبنان على استقلاله وفي ظل الجمهورية الاولى، ذلك أن شهداء عامي 1915 و1916 الذين قضى عليهم جمال باشا الجزار في ظل الحكم العثماني الذي عُرِف باستبداده قام بإعدامهم علناً وفي الساحات، في دمشق وفي بيروت في نفس الوقت وبعد محاكمة ولو صُوَرية وشكلية. بينما تحول الأمر لاحقاً الى عمليات اغتيال تتم في العتمة ولا يجرؤ فيها القاتل أن يُعلِن عن نفسه. فيظل مجهولا ً ولو أن أصابع الاتهام تشير في أحيان كثيرة الى الجهة المستفيدة وربما الجهات التي تتنوع بتنوع الاغتيالات وأسبابها. ربما ذلك يجعلنا نتلمس محاولة فهم استسهال القتل هذا.
من الإعدامات الى الاغتيالات
لكن ما الذي يجمع بين الشهداء الأوائل والذين تكونوا من شخصيات منوعة ذات اتجاهات سياسية متناقضة تدرجت من اليسار الى اليمين ومن المطالبين بالقومية والوحدة العربية الى أولئك المنادين بالقومية اللبنانية. كما انهم من مختلف الطوائف والمذاهب، ومنهم السياسي أورجل الدين أو الصحافي ومهن أخرى مختلفة. مع ملاحظة أن معظم الذين استشهدوا كانوا من الجسم الصحافي. ولقد سبق أن أشار إلى ذلك غسان تويني ناشر النهار غداة مقتل سمير قصير ونقيب الصحافة في إحدى مناسبات ذكرى الشهداء في 6 أيار إلى أن أكثر من ثلث من أعدمهم جمال باشا كانوا من الصحافيين وعددهم 15 صحافياً.
يورد وجيه كوثراني حول الموضوع ما يلي:"اوقف العشرات من الاشخاص في تموز عام 1915 .. وقد امتد القمع بعدها الى كل المناطق في ولايتي بيروت ودمشق. وفي 20 آب 1915 وبناء على الاحكام الصادرة من قبل محكمة عاليه، شنق 11 شخصا في ساحة البرج التي دعيت فيما بعد ساحة الشهداء في بيروت.
..وقد تتابعت حملات التوقيف والحكم بالاعدام. وفي ايار 1916 شنق واحد وعشرون متهماً في بيروت ودمشق. كما ان احكام الاعدام بالموت والتوقيفات تتابعت بحق اشخاص عديدين: 61 شخصا حكم عليهم بالموت خطأ، كما ان أحكام نزع ملكية ونفي صدرت بحق عائلات بأكملها. كل فرد له ادنى علاقة باللجان القديمة او بالقنصليات الاجنبية في بيروت ودمشق هو مشبوه وملاحق. .. هذا القمع الشديد لم يكن يتناسب في عنفه مع الحجم الفعلي للحركات السياسية التي كانت قد بدأت ترى النور في جبل لبنان وفي ولايتي بيروت ودمشق، لأن هذه الحركات لم تكن غير متناسقة وموحدة في برنامجها وميولها فحسب، بل ايضا وخاصة، انها كانت غير قادرة في الداخل على وضع مصالح تركيا في خطر. فالبعض، المسيحيون، كانوا يتطلعون الى التدخل الفرنسي. ولكن كان من بينهم من لا يهمه الا لبنان فقط، وغيرهم ممن لا يدعون الا الى الوحدة السورية تحت الحماية الفرنسية. بالنسبة للاخرين، المسلمين عامة، كان أملهم يتركز في تطبيق اللامركزية وتحقيق "حقوق العرب" داخل الدولة العثمانية، وكانت وسائل نضالهم، كما رأينا في مواقف "النخبة" المنتمية الى العائلات الوجيهة المدينية والبرجوازية الناشئة، ترتكز على إحياء الحضارة العربية الكلاسيكية بواسطة "التربية" و"التعليم". انه اذن وبكلمة واحدة "طموح رومانطيقي" جاء الاضطهاد العنصري الذي مارسه جمال باشا ليزيده حدة وقوة"....
ويتابع في مكان آخر:" من غير المفيد اذن ان نستدرج الى نقاشات "حقوقية" شكلية او اخلاقية لتثبيت الصفة الاستبدادية والتعسفية لسياسة جمال باشا وتأكيد براءة المتهمين. فما هو مؤكد بالنسبة لنا ان "تصفية الحساب" هذه مع المعارضين، مهما كانت مواقف هؤلاء، تجد تفسيرها في السياسة الديكتاتورية العسكرية التي اصابت بقمعها، ليس فقط العرب من مسلميبن ومسيحيين، بل ايضا العديد من الليبراليين الاتراك. ولم تكن العرقية التركية التي ارتكز اليها النظام العسكري الا لتزيد التوجه القمعي حدة وعنفاً" .
يمكن أن نستنتج إذن أن ما كان يجري كان مجرد نشاط سياسي كان قد بدئ به قبل الحرب العالمية الاولى على قاعدة برنامج سياسي سائد هو برنامج الاصلاح اللامركزي.
من الملاحظ أن القاسم المشترك بين هؤلاء الشهداء جميعهم كان الاعتراض على واقع سياسي واجتماعي معين والمطالبة بإصلاحه ومن ضمن توجهات قد تكون مختلفة ومتعارضة فيما بينها. أي أنهم معارضون يحلمون بتغيير الواقع الذي يعيشونه تحت شعارات اصلاحية عامة، دون توافق على البديل، بوسائل سلمية ولا تخرج عن حرية التعبير عن الرأي، سواء كان ذلك تحت هيمنة السلطنة العثمانية أو في ظل دولة الاستقلال.
العنف المؤسِّس
تم افتتاح مسلسلات الاغتيال فيها مع اغتيال رئيس الحكومة وأحد أهم رجالات الاستقلال رياض الصلح في العام 1951 في طريقه إلى المطار في عمّان بعد زيارة له للملكة الأردنية. وظل اغتياله:" لغزا كبيرا، بعضه كَامِنٌ لدى الحزب السوري القومي الذي اغتاله وهو في ضيافة الأردن. وبعض اللغز كامن عند المؤرخين الذين لا يجرؤون على البحث والتنقيب، وأكتفي بالقول إن رياض كان رمزا وضامنا لعروبة لبنان، وواضعا لهذه الدولة الصغيرة الذي كان القاسم المشترك الأعظم في استقلالها، في صميم الحضن العربي للمحافظة على استقرارها واستقلالها" . وتذكر مصادر الحزب القومي السوري أن اغتيال رياض الصلح جاء في سياق الانتقام لإعدام أنطون سعادة .
لذا ربما علينا إعادة العنف في حقبة الاستقلال في ظل الجمهورية الأولى الى اللحظة التي تم فيها إعدام أنطون سعادة في 8\7\1949 والذي جاء رداً على المحاولة الانقلابية التي تم تنفيذها في العام نفسه .
الجامع المشترك
وربما لأن اغتيال رئيس الحكومة رياض الصلح خارج الأراضي اللبنانية، ومع أنه العنف المؤسس الأول في الجمهورية الاولى فغالباً ما يتم التأريخ لعمليات الاغتيال في لبنان مع اغتيال نسيب المتني أيام حكم الرئيس شمعون. لكن ربما يجدر بنا هنا إرجاع افتتاح دائرة العنف بعد الاستقلال الى محاولة الانقلاب هذه وما تبعها من إعدام ومن ثم الاغتيال كرد فعل ثأري. ثم تتابعت الاغتيالات على دفعات في ظل الصراع السياسي الأهلي والعقائدي إبان الحرب الأهلية في الثمانينات ومن ثم في ظل الهيمنة السورية وبعد انتفاضة 14 آذار لاحقاً.
كيف يمكن اختصار الجامع المشترك بين جميع هؤلاء الشهداء، ومنذ 1915 وحتى الآن؟ إنه النضال السلمي وبالكلمة من أجل تغيير واقع سياسي استبدادي أوقمعي أو فاسد. وفعل القتل الذي تعرضوا له يدخل في باب الرقابة العريض ومن ضمن رفض الاعتراف بالرأي الآخر ورفض الحق بالاختلاف سواء السياسي او الفكري أوالعقائدي. فالاغتيال هو نوع من رقابة على الفكر محمولة إلى حدها الأقصى: القضاء جسدياً على من يحمل أو يعمل على نشر أفكار لا تناسب الطرف المتضرر. وهو عامة طرف ممسك بسلطة ما تبدو مهدَّدة، سواء أكانت تنفيذية أو معنوية، سياسية أو دينية، محلية أو اقليمية.. لكن الفارق بين شهداء 1914- 1916 وشهداء ما بعد الاستقلال هو أن ما قام به ممثل ما نطلق عليه "الاستبداد العثماني" قام به علناً وبعد نوع من محاكمات، ولو صورية. بينما ما عرفناه خلال حقبة ما بعد الاستقلال تحوّل فيها الاغتيال الى نوع من "إخبار" أو "تبليغ"، بعدم قبول اتجاه سياسي معين أو أفكار أو ممارسات معينة والاستعداد "لاجتثاثها من جذورها" وإسكاتها الى الأبد. وهذه هي الرقابة في حدّها الأقصى.
ان كثافة عمليات الاغتيال او محاولات القيام بها تجعلنا نعتبر ان الاغتيال في لبنان بعد الاستقلال تحول الى لغة تخاطب وأداة عمل سهلة التنفيذ. تورد الدولية للمعلومات عن حصول 220 عملية اغتيال ومحاولات اغتيال حتى نهاية العام 2005 تلاها 6 اغتيالات منذ ذلك الحين ويصبح المجموع 226 عدا الذين لم يذكروا للسهو أو الخطأ. ولقد طال الاغتيال 14 صحافياً التالية اسماءهم: نسيب المتني، كامل مروة، غسان كنفاني، كارل روبير نفر، عادل عبد المجيد وصفي، سليم اللوزي، رياض طه، يحيى الحزوري، سمير عاصم الشيخ، حسن فخر، حسين مروة، حسن بزون، سمير قصير.
ويضيف غسان تويني الأسماء التالية: وسيم تقي الدين، ادوار صعب، نايف شبلاق، الياس شلالا، محمد الحوماني، سهيل طويلة، حسين مروة، حسن حمدان، محمد شقير. وذلك قبل اغتيال جبران التويني بالطبع. يكون عدد الصحافيين المغتالين منذ الاستقلال وحتى الآن بحسب هذه اللائحة: 22 صحافيا ومع جبران التويني يصبح العدد 23.
اما عدد رجال الدين الذين اغتيلوا بحسب الدولية للمعلومات فبلغ 18 ، وعدد السياسيين 58 تبعهم بعد العام (2005) 3 شهداء جدد ليصبح المجموع 61.
الكتابة كفعل مقاومة
بالطبع عندما نتحدث في بلادنا عن المقاومة، فإن أول ما يتبادر الى الذهن هو المقاومة المسلحة التي يغلب عليها منطق العنف ذو الطابع العسكري. لكن للمقاومة منطق ووسائل مختلفة وهي يمكن ان تكون مقاومة من دون عنف كتلك التي سبق أن أرساها غاندي. وهنا لا بد من الإشارة الى الشعار الذي أطلقه أحد رموز المقاومة اللبنانية وهو الشهيد راغب حرب عندما أطلق برنامجه للمقاومة عبر شعاره البسيط :"الموقف سلاح". أما الإمام موسى الصدر فلقد سبق له أن أعلن في تأبينه لكامل مروة:"الصحافة من أهم ميادين الجهاد وأدقها، لانها هي التي تكوّن الرأي العام".
إذا اعتمدنا إذن تعريف أن الموقف سلاح والصحافة جهاد، يتخذ فهمنا لفعل المقاومة عندها بعده الواسع وغير المحصور بالمعنى العسكري؛ وتحمل الكلمة معنى الجهاد والصمود في مواقف معينة. وهذا الفهم على كل حال هو ما تركز عليه القواميس بشكل عام سواء أكانت باللغة الانجليزية او الفرنسية او العربية؛ ففي لسان العرب ترد كلمة مقاومة في سياق كلمة قوم وقيام، عكس جلوس، وبمعنى العَزْم خاصة. ويأتي في المعنى أيضاً المحافظة والإصلاح ويجئ القيام أيضاً بمعنى الوقوف والثبات.
المقاومة قد تكون غير مسلحة إذن وهذا ما يفسر ذلك القتل المتكرر الذي يتعرض له الكتّاب والصحافيين والسياسيين ورجال الدين في لبنان والذي يجعل ممكناً هذا الكم من الدم المسفوك والقتل السهل والروتيني لكل من يعارض حاملاً مجرد قلم و صوت؟؟؟
لهذا السبب يمكن أن نطلق على شهداء الكلمة هؤلاء نعت مقاومين بامتياز. لأن مراجعة سير بعض الشهداء من الصحافيين تؤكد كونهم رواداً للمقاومة من أجل الحق بحرية التعبير وحرية الفكر وإعلان الحقيقة.
انواع الاغتيال
ليس للاغتيال كرقابة محمولة على حدها الاقصى كما سبق وقلنا، من منطق او نظام متسق. فأحياناً تكون عشوائية لأن جوهرها ومفهومها نفسه هو كذلك. يجدر بالرقابة ان تكون اعتباطية، يستحيل التنبؤ بأفعالها لأن وجود المنطق أو القانون يتنافى مع وجودها ويبطل مفاعيله. الرقابة لا تحتاج الى قانون لأنها ضد أي قانون. كما أن الحرية لا تحتاج الى قانون.
ولبنان ليس دولة مستبدة تمارس الاغتيال، لكن ليست جميع الاغتيالات "لبنانية" ولا الاستبداد صفة ملازمة للدول فقط، بل هي تشمل الافراد كالزعامات والجماعات كالاحزاب. فلبنان كان الساحة التي استباحتها كافة الأطراف الخارجية، بدءاً بدولة الاحتلال الأخيرة في العالم، أي إسرائيل، مروراً بالقوى الغربية وصولاً الى الانظمة الشقيقة والصديقة متعددة التوجه والقرب او البعد الجغرافي أو أحزاب عقائدية او جهات ومجموعات إرهابية أصولية. وكما نعلم ليس للاغتيال كرقابة وقمع سوى رسالة واحدة: ممارسة الإرهاب من أجل القضاء على أي مقاومة أو صوت أو معتقد مختلف.. أو أي صوت حرّ.
وإذا كان من غير الممكن القضاء على إرهاب الدولة الإسرائيلية المحتلة إلا بالقضاء على الاحتلال وبإحلال السلم الحقيقي، يظل بإمكاننا ومن واجبنا مواجهة الاغتيالات المحلية الطابع والتي تمارس من جميع الأفرقاء الآخرين سواء أكانوا أشقاء أم قوى أقليمية ومخابراتية مختلفة، والتي تهدف الى إسكات الصوت الآخر المختلف والقضاء على أي معارضة سياسية.
من هنا يبدو أن وضع نسق معين للاغتيال ليس سهلاً ولكنه نوع من تمرين يسهّل محاولة الفهم ليس إلا. فعدا عن الاغتيالات المباشرة وغير المباشرة التي نفذتها اسرائيل والتي لن نتوسع فيها لأنها تصنف ضمن الإرهاب الإسرائيلي الممارس من قبل دولة محتلة والمدان حكماً. لكن سوف نحاول تضمين الاغتيالات الاخرى التي لم يكن واضحاً فيها العامل الاسرائيلي أو أنه لم يتأكد لأن "ظلم ذوي القربى أشد مضاضة".
يصعب تحديد صفة واحدة للاغتيال فهو مصطلح يستعمل لوصف عملية قتل منظمة ومتعمدة تستهدف شخصية مهمة أو قيادية ذات تأثير فكري أو سياسي أو عسكري وتكون أسباب عملية الاغتيال عادة إما عقائدية أو سياسية أو إقتصادية أو إنتقامية تستهدف شخصا معينا يعتبره منظموا عملية الاغتيال عائقا في طريق إنتشار أوسع لأفكارهم أو أهدافهم .
لسنا في صدد مراجعة كاملة وتصنيف للاغتالات العديدة التي حصلت في لبنان، لكن ما نقوم به هو نوع من المساعدة على فهم انواع الاغتيال مما يساهم ربما في تلمس بعض الأسباب المؤدية له وتدخل فيها جميع عوامل الانتقام والتحذير والترهيب والقمع. على كل حال نجحت موجة الاغتيالات التي حصلت في الثمانينات في فرض نوع من الرقابة الذاتية طالت الصحف والنشرات الاخبارية والتلفزيونات والحياة السياسية عامة وجميع أشكال التعبير والتواصل. وربما كانت هذه الرقابة الذاتية أحد الأهداف الأساسية المضمرة لهذه الاغتيالات وهي قد نجحت في الوصول الى غايتها لأنها كما نعلم كونها مموهة وتغيّب أي اعتراض علني تجعل الأمور تبدو طبيعية فتكون أقوى وأفعل من الرقابات الأخرى . وتوفر على من يقوم بها صفة القمع والاستبداد موحية بوجود حريات عامة وحرية تعبير ..
اغتيال "وطني" بمعنى محلي وتمرين العنف الأول
شكّل اغتيال نسيب المتني ، نقيب المحررين السابق، صاحب ورئيس تحرير اليومية المعارضة "التلغراف" والمعروف بانتقاداته الحادة لسياسة الرئيس شمعون الخارجية وللفساد في عهده ، فاتحة الاغتيالات السياسية لصحافي بعد الاستقلال. كان اغتيال المتني عام 1958 «صُنع في لبنان» مئة في المئة، على عكس الاغتيالات اللاحقة. دفع المتني دمه ثمناً لموقفه السياسي وبسبب معارضته لسياسات الرئيس. فلقد وقف بكل ما أوتي من قوة ضد التجديد لرئيس الجمهورية، معتبراً ان «التمديد جريمة»، ومعلناً معارضته "الاعتداء على الدستور... وفرض شخص لمدة 12 سنة، حتى لو كان أقرب أقربائنا وأعز أصدقائنا" .
شكل اغتياله الشرارة التي أطلقت موجة عنف في اليوم التالي لاغتياله، فدعت المعارضة الى الاضراب العام وفي يوم التشييع انطلقت تظاهرات عارمة في عكار والمنية والشوف والبقاع وصيدا، عبرت عن الغضب والاستنكار تجاه الاحلاف العسكرية الاجنبية وطالبت باستقالة شمعون. وفي طرابلس اشتبك انصار رشيد كرامي مع الجيش وفي بيروت الغربية ظهرت المتاريس في الشوارع. لـ «يُدشّن» باغتياله عهد جديد من «ترهيب» قادة الرأي. وكان ذلك بداية ما عرف بأحداث العام 1958.
الاغتيال ذو الطابع الاقليمي
جاء اغتيال كامل مروة بعد ذلك بعدة سنوات ليدشن حقبة الاغتيال لمصلحة جهات خارجية. تكمن أهمية كامل مروة في مساهمته الفاعلة في تطوير الصحافة اللبنانية، إخراجاً وإنتاجاً وتحريراً. فإلى ابتكاره الافتتاحية القصيرة، في زمن المطوّلات أو المعلقات الصحافية، أدخل المكننة الى دنيا الصحافة في لبنان والعالم العربي، فلقّب بأبي الصحافة العربية الحديثة.
أما في السياسة، فلم ينجذب الى الأفكار الثورية والاشتراكية التي سادت خلال الخمسينات والستينات من القرن المنصرم، في عدد من الدول العربية. بل عارضها بشدة عبر افتتاحياته التي كان يتابعها صانعو القرار في الوطن العربي بانتظام. لكن المعارضة السلمية لم تكن مقبولة – ولا تزال- في الوقت الذي استتبت فيه السلطات في عدد من الانظمة العربية عن طريق الانقلابات العسكرية. وجاء في سياق الحديث عن قليلات الذي قيل انه المحرض على الاغتيال "أن الحياة كانت أداة بارزة في خدمة سياسات الدول الغربية.. وانها تحولت الى مؤسسة ضخمة بفعل أموال السعودية" !! وكأننا في بلاد تجترّ نفسها وتستعيد كلشيهاتها دون كلل ... اما مروة فكان قد كتب في افتتاحية جريدة الحياة عام 1965:"إن معاملة المواطنين كشعب محتل، لا قول له ولا رأي ولا حرية، ليست من مقومات البقاء ولا من دلائل العافية». وربما مثل هذه الممارسات هي التي ساهمت في تدهور فكرة العروبة وتأزمها.
اغتيل مروّة بعد عشرين عاماً من نضال صحافي على صفحات «الحياة»، والقلم في يده، كاتباً افتتاحية السابع عشر من أيار 1966، والتي لم تكتمل. فصدر عدد ذلك اليوم من الصحيفة وعلى صفحتها الأولى خبر وحيد وحزين: «اغتيال كامل مروّة في مكتبه".
وهو نموذج للاغتيال ذو الطابع الاقليمي لأن الكثير من تلك التي حصلت في لبنان كان لها هذا الطابع مع اغتيال المناضل موسى شعيب واغتيال كمال جنبلاط او اختفاء الامام موسى الصدر واغتيال المفتي حسن خالد وصولاً الى ما بعد انتفاضة 14 آذار والتي طالت سياسيين وصحافيين. وآخر اغتيال من هذا النوع حتى الآن كان عماد مغنية أبرز قادة حزب الله العسكريين في دمشق . ولقد اتهم الحزب إسرائيل بهذا الاغتيال.
حقبة اغتيالات القمع والارهاب الفكريين والعقائديين
أما أكثر الاغتيالات تجسيداً للدور النضالي والفعل المقاوم الذي يقوم به الصحافي فتؤكدها الطريقة فائقة الوحشية التي تمت فيها تصفية سليم اللوزي في 4 آذار 1980 والتي شكلت رسالة إرهاب صاعقة لكل من يحذو حذوه. اختطف اللوزي ونقل الى منطقة عاليه ثم وجد جسده في ساعات المساء المتأخرة مرمياً في دغل من الأشجار. في مؤخرة الرأس طلق ناري حطّم الجمجمة ومزّق الدماغ. ذراعه اليمنى مسلوخ لحمها عن عظمها حتى الكوع، والأصابع الخمس سوداء نتيجة التذويب بالأسيد أو حامض الكبريت بينما لسانه مقطوعا من جذوره وكان رأسه مفجراً برصاصة اخترقته من جانب الى الآخر و كانت اذناه مصلومتين وعيناه مفقوءتين. كما عثر على أقلام الحبر مغروزة بعنف داخل أحشائه من الخلف... في مشهد تعذيب ساديّ شديد التعبير عن الغاية من القتل. الانتقام من فعل الكتابة نفسه ومن كل من يرى ويسمع وينطق.
أما السبب فلأنه ذو لسان جريء، وقلم لاذع، ورأي صادم غير مهادن. الذنب الذي اقترفه سليم اللوزي الذي اعتقد انه غدا بعيداً وبأمان في العاصمة البريطانية التي عاد منها ليومين من اجل المشاركة في جنازة والدته كان اصداره "الحوادث" في اسبوعين متلاحقين بغلافين مثيرين واستفزازيين الأول هو "عقدة العقيد"، والثاني هو "عندما يكذب النظام". ولطالما ناضل اللوزي بالكلمة من أجل إيصال الحقيقة والدفاع عنها وتعرض للملاحقة والطرد من أكثر من بلد عربي. ولكن يبدو أن عناده الذي لا يشبهه فيه الا عناد جبران التويني، آخر شهداء الصحافة، هو ما جعله يطمئن الى الضمانات التي حصل عليها قبل ان يعود الى لبنان تلك العودة الاخيرة .. وتبين انه لم يكن على حق بتكراره بانه اقوى من الخطف واقوى من القتل، لأن هيبة الكلمة برأيه، هي أقوى من هيبة المسدس. ولقد خدم اغتياله في ترسيخ القمع والخوف في نفوس الصحافيين المقاومين للتسلط والقمع.
أما رياض طه الذي سبق وتعرض للاغتيال في العام 1947 بسبب مقالاته ضد الاقطاعية والاجرام وبيع الوظائف والسمسرة والاثراء غير المشروع، فكان قد نشر مقالا عنيفا بعنوان "خصمي وحاكمي" الذي كان كافيا لأن يصدر قرارا من مجلس الوزراء بتعطيل الصحيفة الى أجل غير مسمى. كما جرت محاولة فاشلة اخرى لاغتياله في العام 1952، وقد تبنت نقابة الصحافة المقال الذي سبب الاعتداء. ونشرته سائر الصحف لتردع الزعماء الذين يلجأون الى هذا الاسلوب في الرد على الصحافيين.
ولقد تم اغتيال رياض طه نقيب الصحافة اللبنانية في 23 تموز 1980، وبعد 4 أشهر تقريبا على اغتيال سليم اللوزي، عندما اعترض سيارته مسلحون يستقلون ثلاث سيارات في منطقة الروشة في بيروت، وأطلقوا النار عليه وفروا الى جهة مجهولة . كان رياض طه يكتب عن التجاوزات السورية والفلسطينية ايضا. وكان يحاول تقريب وجهات النظر بين العراق والكويت وسوريا والعراق وبين الأفرقاء اللبنانيين. كما ربط بين اغتياله والحرب العراقية – الايرانية من بين اغتيالات اخرى: عبد الوهاب الكيالي، موسى شعيب.. وتعد هذه السيرة بامتياز سيرة "مقاوم" وطني لبناني ومدافع عن حرية التعبير في إطار سلطة الدولة الوطنية.
ويدخل في هذه الفئة عدد من الاغتيالات في أعوام الثمانينيات وطالت عدداً من المفكرين متنوعي التوجهات منهم: الشيخ الدكتور صبحي الصالح 1927 – 1986. كما عرفت بعض الاغتيالات ذات الطابع العقائدي وهي تدخل في سياق القمع والقضاء على الشبيه الذي يسبب الخوف لأنه يحمل صورتنا الى اقصاها، من هنا ضرورة القضاء عليه. ونموذج هذا الاغتيال المفكر حسين مروة (1908- 1987)، الشيخ المرتد شكل ايضا نموذجا مسيئاً ومخيفا وحاملا للضرر، من هنا ربما اغتياله. أيضاً يدخل اغتيال حسن حمدان (1936- 1987) في هذا السياق، فمهدي عامل الشيوعي الملحد الذي ذهب بخياره الى الحد الذي شكل تحديا حقيقيا ومنافسة لمن كانوا معه على نفس الخط وتحوّلوا الى نقيضه فتم القضاء عليه. وهي امثلة تشكل عالى كل حال تحذيرا للآخرين أن انتبهوا ما سوف يصيبكم اذا ما فعلتم بالمثل. ولقد نجح هذا الترويع لفترة كافية. اختتمت الثمانينيات مع اغتيال المفتي الشيخ حسن خالد1921- 1989.
خفت عمليات الاغتيال في التسعينات وفيما عدا اغتيال مصطفى جحا الذي أزعج الكثيرين في كتاباته ، مما تمخض عن فتوى تكفيرية صدرت عن المحكمة الجعفرية تمّ تعميمها ونشرها في كافة المحاكم الإسلامية والمرجعيات. تعرض مصطفى جحا لعملية الاغتيال التي أودت بحياته في منطقة الجديدة حيث تم إطلاق النار عليه من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة .
ولقد اختفت الاغتيالات بعد أن استتبت الرقابة الذاتية في أحسن وأنجح حالاتها على الاطلاق، على مستوى الصحافة وقادة الرأي والسياسيين والنخب الحاكمة، فيما عدا قلائل همّشوا عن جنة المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.وعادت الى الظهور انطلاقا من العام 2002 مع اغتيال ايلي حبيقة ذو الطابع الملغز ومتعدد الأسباب. ومن ثم رمزي عيراني في استعادة للقمع والترهيب
كباراً وصغاراً، نساء ورجالاً، ان بسبب الحرب الاهلية او بسبب مختلف الحروب الكبيرة والصغيرة، المذهبية او العصبوية، العقائدية او الارهابية..... والذين يحتاجون إلى عمل مؤسساتي ضخم لكي يتم عمل أرشيف يضم اسماءهم وتواريخ استشهادهم مهما كان سبب القتل الذي وقعوا ضحية له..
إنه أقل ما يتوجب علينا تجاههم.
--------------------------------------
القتل رقابة في حدّها الأقصى
تُعَرَّف الرقابة على انها التضييق العشوائي او العقائدي على حرية التعبير عند كل فرد. وهي تحصل عبر تفحص الكتب والصحف والنشرات الاخبارية والمسرحيات او الافلام من قبل الممسك بالسلطة قبل السماح بإطلاع الجمهور عليها. وبمعنى أشمل، تعيّن الرقابة مختلف الاشكال التي تطال حرية التعبير، قبل نشرها أو بعده. ومنها الرقابة السياسية، عندما تضيّق الحكومة حرية التعبير. وتلك تكون رقابة مباشرة، أما الرقابة غير المباشرة او غير الرسمية، فتحصل بالطرق القمعية، خاصة عندما تكون وسائل الاعلام متمركزة في أيدي قلة مستأثرة وعبر أجهزة مخابراتية وأمنية مستحكمة. ناهيك عن ظاهرة الرقابة الذاتية وهي التي تنتج عن القمع والاضطهاد المستمرين وهي أقصى ما تطمح إليه الأنظمة القمعية لأنه يموّه حقيقة وجود رقابة ملموسة ومفضوحة. لكن الرقابة يمكنها ان تكون مؤسساتية او اجتماعية كما حصل مع اغتيال فرج فوده أو الاعتداء على نجيب محفوظ ونصر حامد ابو زيد.
وظاهرة الرقابة موجودة منذ القدم. فالرقيب وجد في روما القديمة ونظام الحسبة عرف ايام الخلافة الاسلامية. لكن مهمة المراقب في ذلك الوقت كانت الحفاظ على العادات أو منع الغش. وليس الرقابة كما نعرفها الآن.
مع ذلك حظيت الكتب بالرقابة على مرّ العصور. فأحرقت روائع وأعدمت أفكار وعُطّلت طاقات خلاقة...لكن يظل السؤال المثير: هل يجب أن تذهب الرقابة إلى أقصاها بحيث تصل إلى إنزال الموت بإنسان من أجل كتاب؟؟ من أجل فكرة؟ من أجل رأي سياسي؟
سؤال الخصوصية
يحفل التاريخ بالكتب الممنوعة التي عرّضت مؤلفي تلك النصوص على مرّ العصور للسجن أوالنفي أو الموت. الموت حرقاً كان من نصيب Giordano bruno الذي اعتمد على نظرية كوبرنيك لكي يبرهن فلسفياً على لانهائية الكون واحتوائه على أعداد لا تحصى من العوالم الشبيهة بعالمنا.
واستتباعاً، إذا كان التعبير عن الرأي الآخر المختلف ومجرد المطالبة بالإصلاح أو بالتغيير السياسي السلمي مما يستحق القتل من أجله، فماذا يظل أمام المطالبين بهذا التغيير للقيام به؟ هل الرضوخ وتأبيد الحكام والأوضاع السائدة على ما هي عليه في نوع من القبول والتشجيع على أسوأ انواع الاستبداد والطغيان؟ أم التسابق في استخدام العنف والبطش بين المتعارضين من مطالبين بالاصلاح ومن ممسكين بزمام السلطة؟ وندخل عندها في دورات من العنف والثأر والثأر المضاد التي لا يوقفها سوى مزيد من العنف ومن الاستبداد والطغيان من قبل الحاكم الفرد أوالديكتاتوريات او من قبل عسكريين أو حزب أو ما شابه!! وهذا على كل حال ما طبع الأوضاع السياسية في المنطقة العربية منذ نشوء الدولة الوطنية الحديثة.
لقد استطاعت الانظمة الديموقراطية المعاصرة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وقف دورات العنف هذه عن طريق وضع دساتير وقوانين أدى احترامها الى ممارسات ووسائل تعبير سلمية تحفظ الحق بحرية الرأي ما سمح بتداول السلطة سلمياً. لكن بلادنا لم تنجح بعد في دخول هذه الدورة ولا يزال العنف والقمع والاستبداد مسيطراً على معظم الدول العربية.
تميز لبنان بحكم خصوصياته وتنوع مكوناته السكانية بنوع من حرية وديموقراطية. وبيروت التي استحقت ان تكون عاصمة عالمية للكتاب للعام 2009 لتمتعها بدور ثقافي مميز ورائد غطى جزءاً كبيراً من القرن العشرين. كانت قد بنته على مهل منذ القرن التاسع عشر. لكن لم يكن ممكناً حصول ذلك الدور الثقافي بمعزل عن الطلب الخارجي والعربي عليه. فأوضاع الحريات السائدة في العالم العربي الموسومة بطابع الاستبداد، جعل من بيروت ملجأً لكل من ذاق طعم الاضطهاد والقمع السائدين في بلده وضاق بهما. وبذلك اصبحت بيروت مركز الصحافة العربية توَزَّع صحفها في أنحاء العالم العربي. وصارت مجرد الاشارة في هذا العالم الى الصحافة والحريات الصحافية لا بد من أن يعني بيروت. وكل من أراد الوصول الى اوسع عدد من القراء العرب، عليه ان يضمن نشر رأيه في جريدة او مجلة صادرة في بيروت. ما جعل منها في ستينيات القرن الماضي محطة إلزامية للكثير من الأقلام العربية التي لمعت في فضاء الثقافة العربية وفي المهجر. وهذا يطال بالطبع ميادين الأدب والفن والطبع والنشر والترجمة والصحافة.
ذلك كله جعل من بيروت عاصمة الثقافة العربية الأساسية التي ساهمت في إطلاق نهضة ثقافية عربية ولو متفاوتة ومتعثرة في الكثير من الأحيان.
حرية مترسبة
لكن الحرية والتسامح اللذان تمتعت بهما بيروت، وساعد على السماح بهما تعدد الصحف وتنوعها بشكل أساسي، وذلك قبل ان تكبّلها حروبها الأهلية وعصبياتها المتفلتة، كانت بحد ذاتها ما يمكن أن نطلق عليه اسم "حرية مترسبة"، بمعنى انها موجودة بسبب غياب المنع والتغاضي وليس بسبب موقف واعٍ وإيجابي يسمح بتشريعات وقوانين توجد ضوابط واضحة وراسخة للمؤسسات المعنية على طريقة تنظيم الاعلام الانجليزي مثلاً، ما من شأنه حفظ الحقوق لأصحابها. انها إذن الظروف الخاصة واللحظة الراهنة التي تسمح بالتسامح والتغاضي. ويكفي أن يعترض رجل دين أو رجل سياسة أو أي فعالية ثقافية او اجتماعية على كتاب ما أو فيلم أو منتج فني لكي يضع الوزير المختص تحت الضغط ويصبح منعه ممكناً . والدليل على ذلك جميع أشكال المنع والقمع والرقابة التي طالت كتاباً ومخرجين وصحافيين ومغنين (فضلاً عن اعتقال البعض من هؤلاء الأخيرين) والتي ظلت تمارس بشكل متفاوت، حتى في حقبة الحرية الذهبية. وتماماً لأنها تخضع لنزوة رئيس او تسلط جهاز أمني او لمجرد مزاجية الرقيب وميوله، سواء السياسية او الدينية او الفكرية. خاصة أن هذه الرقابة جزء من جهاز أمني وليست جزءاً من المنظومة الثقافية وقيمها.
أمر الرقابة في لبنان لم يقف عند حد المنع والسجن بل تعداهما الى القتل اغتيالاً وفي غالب الأحيان لكتاب أو صحافيين أو ذوي رأي أو سياسيين أورجال دين: من نسيب المتني وكامل مروة الى سمير قصير وجبران تويني مرورا بغسان كنفاني وسليم اللوزي ورياض طه ومهدي عامل وحسين مروة والشيخ صبحي الصالح . وهو لم يبدأ بعد الاستقلال لكنه كان قد بدأ قبل ذلك مع الإعدامات التي نفذها جمال باشا الجزار في عامي 1915 و1916....
والجدير بالملاحظة أن الاغتيالات لم تظهر إلا بعد أن حصل لبنان على استقلاله وفي ظل الجمهورية الاولى، ذلك أن شهداء عامي 1915 و1916 الذين قضى عليهم جمال باشا الجزار في ظل الحكم العثماني الذي عُرِف باستبداده قام بإعدامهم علناً وفي الساحات، في دمشق وفي بيروت في نفس الوقت وبعد محاكمة ولو صُوَرية وشكلية. بينما تحول الأمر لاحقاً الى عمليات اغتيال تتم في العتمة ولا يجرؤ فيها القاتل أن يُعلِن عن نفسه. فيظل مجهولا ً ولو أن أصابع الاتهام تشير في أحيان كثيرة الى الجهة المستفيدة وربما الجهات التي تتنوع بتنوع الاغتيالات وأسبابها. ربما ذلك يجعلنا نتلمس محاولة فهم استسهال القتل هذا.
من الإعدامات الى الاغتيالات
لكن ما الذي يجمع بين الشهداء الأوائل والذين تكونوا من شخصيات منوعة ذات اتجاهات سياسية متناقضة تدرجت من اليسار الى اليمين ومن المطالبين بالقومية والوحدة العربية الى أولئك المنادين بالقومية اللبنانية. كما انهم من مختلف الطوائف والمذاهب، ومنهم السياسي أورجل الدين أو الصحافي ومهن أخرى مختلفة. مع ملاحظة أن معظم الذين استشهدوا كانوا من الجسم الصحافي. ولقد سبق أن أشار إلى ذلك غسان تويني ناشر النهار غداة مقتل سمير قصير ونقيب الصحافة في إحدى مناسبات ذكرى الشهداء في 6 أيار إلى أن أكثر من ثلث من أعدمهم جمال باشا كانوا من الصحافيين وعددهم 15 صحافياً.
يورد وجيه كوثراني حول الموضوع ما يلي:"اوقف العشرات من الاشخاص في تموز عام 1915 .. وقد امتد القمع بعدها الى كل المناطق في ولايتي بيروت ودمشق. وفي 20 آب 1915 وبناء على الاحكام الصادرة من قبل محكمة عاليه، شنق 11 شخصا في ساحة البرج التي دعيت فيما بعد ساحة الشهداء في بيروت.
..وقد تتابعت حملات التوقيف والحكم بالاعدام. وفي ايار 1916 شنق واحد وعشرون متهماً في بيروت ودمشق. كما ان احكام الاعدام بالموت والتوقيفات تتابعت بحق اشخاص عديدين: 61 شخصا حكم عليهم بالموت خطأ، كما ان أحكام نزع ملكية ونفي صدرت بحق عائلات بأكملها. كل فرد له ادنى علاقة باللجان القديمة او بالقنصليات الاجنبية في بيروت ودمشق هو مشبوه وملاحق. .. هذا القمع الشديد لم يكن يتناسب في عنفه مع الحجم الفعلي للحركات السياسية التي كانت قد بدأت ترى النور في جبل لبنان وفي ولايتي بيروت ودمشق، لأن هذه الحركات لم تكن غير متناسقة وموحدة في برنامجها وميولها فحسب، بل ايضا وخاصة، انها كانت غير قادرة في الداخل على وضع مصالح تركيا في خطر. فالبعض، المسيحيون، كانوا يتطلعون الى التدخل الفرنسي. ولكن كان من بينهم من لا يهمه الا لبنان فقط، وغيرهم ممن لا يدعون الا الى الوحدة السورية تحت الحماية الفرنسية. بالنسبة للاخرين، المسلمين عامة، كان أملهم يتركز في تطبيق اللامركزية وتحقيق "حقوق العرب" داخل الدولة العثمانية، وكانت وسائل نضالهم، كما رأينا في مواقف "النخبة" المنتمية الى العائلات الوجيهة المدينية والبرجوازية الناشئة، ترتكز على إحياء الحضارة العربية الكلاسيكية بواسطة "التربية" و"التعليم". انه اذن وبكلمة واحدة "طموح رومانطيقي" جاء الاضطهاد العنصري الذي مارسه جمال باشا ليزيده حدة وقوة"....
ويتابع في مكان آخر:" من غير المفيد اذن ان نستدرج الى نقاشات "حقوقية" شكلية او اخلاقية لتثبيت الصفة الاستبدادية والتعسفية لسياسة جمال باشا وتأكيد براءة المتهمين. فما هو مؤكد بالنسبة لنا ان "تصفية الحساب" هذه مع المعارضين، مهما كانت مواقف هؤلاء، تجد تفسيرها في السياسة الديكتاتورية العسكرية التي اصابت بقمعها، ليس فقط العرب من مسلميبن ومسيحيين، بل ايضا العديد من الليبراليين الاتراك. ولم تكن العرقية التركية التي ارتكز اليها النظام العسكري الا لتزيد التوجه القمعي حدة وعنفاً" .
يمكن أن نستنتج إذن أن ما كان يجري كان مجرد نشاط سياسي كان قد بدئ به قبل الحرب العالمية الاولى على قاعدة برنامج سياسي سائد هو برنامج الاصلاح اللامركزي.
من الملاحظ أن القاسم المشترك بين هؤلاء الشهداء جميعهم كان الاعتراض على واقع سياسي واجتماعي معين والمطالبة بإصلاحه ومن ضمن توجهات قد تكون مختلفة ومتعارضة فيما بينها. أي أنهم معارضون يحلمون بتغيير الواقع الذي يعيشونه تحت شعارات اصلاحية عامة، دون توافق على البديل، بوسائل سلمية ولا تخرج عن حرية التعبير عن الرأي، سواء كان ذلك تحت هيمنة السلطنة العثمانية أو في ظل دولة الاستقلال.
العنف المؤسِّس
تم افتتاح مسلسلات الاغتيال فيها مع اغتيال رئيس الحكومة وأحد أهم رجالات الاستقلال رياض الصلح في العام 1951 في طريقه إلى المطار في عمّان بعد زيارة له للملكة الأردنية. وظل اغتياله:" لغزا كبيرا، بعضه كَامِنٌ لدى الحزب السوري القومي الذي اغتاله وهو في ضيافة الأردن. وبعض اللغز كامن عند المؤرخين الذين لا يجرؤون على البحث والتنقيب، وأكتفي بالقول إن رياض كان رمزا وضامنا لعروبة لبنان، وواضعا لهذه الدولة الصغيرة الذي كان القاسم المشترك الأعظم في استقلالها، في صميم الحضن العربي للمحافظة على استقرارها واستقلالها" . وتذكر مصادر الحزب القومي السوري أن اغتيال رياض الصلح جاء في سياق الانتقام لإعدام أنطون سعادة .
لذا ربما علينا إعادة العنف في حقبة الاستقلال في ظل الجمهورية الأولى الى اللحظة التي تم فيها إعدام أنطون سعادة في 8\7\1949 والذي جاء رداً على المحاولة الانقلابية التي تم تنفيذها في العام نفسه .
الجامع المشترك
وربما لأن اغتيال رئيس الحكومة رياض الصلح خارج الأراضي اللبنانية، ومع أنه العنف المؤسس الأول في الجمهورية الاولى فغالباً ما يتم التأريخ لعمليات الاغتيال في لبنان مع اغتيال نسيب المتني أيام حكم الرئيس شمعون. لكن ربما يجدر بنا هنا إرجاع افتتاح دائرة العنف بعد الاستقلال الى محاولة الانقلاب هذه وما تبعها من إعدام ومن ثم الاغتيال كرد فعل ثأري. ثم تتابعت الاغتيالات على دفعات في ظل الصراع السياسي الأهلي والعقائدي إبان الحرب الأهلية في الثمانينات ومن ثم في ظل الهيمنة السورية وبعد انتفاضة 14 آذار لاحقاً.
كيف يمكن اختصار الجامع المشترك بين جميع هؤلاء الشهداء، ومنذ 1915 وحتى الآن؟ إنه النضال السلمي وبالكلمة من أجل تغيير واقع سياسي استبدادي أوقمعي أو فاسد. وفعل القتل الذي تعرضوا له يدخل في باب الرقابة العريض ومن ضمن رفض الاعتراف بالرأي الآخر ورفض الحق بالاختلاف سواء السياسي او الفكري أوالعقائدي. فالاغتيال هو نوع من رقابة على الفكر محمولة إلى حدها الأقصى: القضاء جسدياً على من يحمل أو يعمل على نشر أفكار لا تناسب الطرف المتضرر. وهو عامة طرف ممسك بسلطة ما تبدو مهدَّدة، سواء أكانت تنفيذية أو معنوية، سياسية أو دينية، محلية أو اقليمية.. لكن الفارق بين شهداء 1914- 1916 وشهداء ما بعد الاستقلال هو أن ما قام به ممثل ما نطلق عليه "الاستبداد العثماني" قام به علناً وبعد نوع من محاكمات، ولو صورية. بينما ما عرفناه خلال حقبة ما بعد الاستقلال تحوّل فيها الاغتيال الى نوع من "إخبار" أو "تبليغ"، بعدم قبول اتجاه سياسي معين أو أفكار أو ممارسات معينة والاستعداد "لاجتثاثها من جذورها" وإسكاتها الى الأبد. وهذه هي الرقابة في حدّها الأقصى.
ان كثافة عمليات الاغتيال او محاولات القيام بها تجعلنا نعتبر ان الاغتيال في لبنان بعد الاستقلال تحول الى لغة تخاطب وأداة عمل سهلة التنفيذ. تورد الدولية للمعلومات عن حصول 220 عملية اغتيال ومحاولات اغتيال حتى نهاية العام 2005 تلاها 6 اغتيالات منذ ذلك الحين ويصبح المجموع 226 عدا الذين لم يذكروا للسهو أو الخطأ. ولقد طال الاغتيال 14 صحافياً التالية اسماءهم: نسيب المتني، كامل مروة، غسان كنفاني، كارل روبير نفر، عادل عبد المجيد وصفي، سليم اللوزي، رياض طه، يحيى الحزوري، سمير عاصم الشيخ، حسن فخر، حسين مروة، حسن بزون، سمير قصير.
ويضيف غسان تويني الأسماء التالية: وسيم تقي الدين، ادوار صعب، نايف شبلاق، الياس شلالا، محمد الحوماني، سهيل طويلة، حسين مروة، حسن حمدان، محمد شقير. وذلك قبل اغتيال جبران التويني بالطبع. يكون عدد الصحافيين المغتالين منذ الاستقلال وحتى الآن بحسب هذه اللائحة: 22 صحافيا ومع جبران التويني يصبح العدد 23.
اما عدد رجال الدين الذين اغتيلوا بحسب الدولية للمعلومات فبلغ 18 ، وعدد السياسيين 58 تبعهم بعد العام (2005) 3 شهداء جدد ليصبح المجموع 61.
الكتابة كفعل مقاومة
بالطبع عندما نتحدث في بلادنا عن المقاومة، فإن أول ما يتبادر الى الذهن هو المقاومة المسلحة التي يغلب عليها منطق العنف ذو الطابع العسكري. لكن للمقاومة منطق ووسائل مختلفة وهي يمكن ان تكون مقاومة من دون عنف كتلك التي سبق أن أرساها غاندي. وهنا لا بد من الإشارة الى الشعار الذي أطلقه أحد رموز المقاومة اللبنانية وهو الشهيد راغب حرب عندما أطلق برنامجه للمقاومة عبر شعاره البسيط :"الموقف سلاح". أما الإمام موسى الصدر فلقد سبق له أن أعلن في تأبينه لكامل مروة:"الصحافة من أهم ميادين الجهاد وأدقها، لانها هي التي تكوّن الرأي العام".
إذا اعتمدنا إذن تعريف أن الموقف سلاح والصحافة جهاد، يتخذ فهمنا لفعل المقاومة عندها بعده الواسع وغير المحصور بالمعنى العسكري؛ وتحمل الكلمة معنى الجهاد والصمود في مواقف معينة. وهذا الفهم على كل حال هو ما تركز عليه القواميس بشكل عام سواء أكانت باللغة الانجليزية او الفرنسية او العربية؛ ففي لسان العرب ترد كلمة مقاومة في سياق كلمة قوم وقيام، عكس جلوس، وبمعنى العَزْم خاصة. ويأتي في المعنى أيضاً المحافظة والإصلاح ويجئ القيام أيضاً بمعنى الوقوف والثبات.
المقاومة قد تكون غير مسلحة إذن وهذا ما يفسر ذلك القتل المتكرر الذي يتعرض له الكتّاب والصحافيين والسياسيين ورجال الدين في لبنان والذي يجعل ممكناً هذا الكم من الدم المسفوك والقتل السهل والروتيني لكل من يعارض حاملاً مجرد قلم و صوت؟؟؟
لهذا السبب يمكن أن نطلق على شهداء الكلمة هؤلاء نعت مقاومين بامتياز. لأن مراجعة سير بعض الشهداء من الصحافيين تؤكد كونهم رواداً للمقاومة من أجل الحق بحرية التعبير وحرية الفكر وإعلان الحقيقة.
انواع الاغتيال
ليس للاغتيال كرقابة محمولة على حدها الاقصى كما سبق وقلنا، من منطق او نظام متسق. فأحياناً تكون عشوائية لأن جوهرها ومفهومها نفسه هو كذلك. يجدر بالرقابة ان تكون اعتباطية، يستحيل التنبؤ بأفعالها لأن وجود المنطق أو القانون يتنافى مع وجودها ويبطل مفاعيله. الرقابة لا تحتاج الى قانون لأنها ضد أي قانون. كما أن الحرية لا تحتاج الى قانون.
ولبنان ليس دولة مستبدة تمارس الاغتيال، لكن ليست جميع الاغتيالات "لبنانية" ولا الاستبداد صفة ملازمة للدول فقط، بل هي تشمل الافراد كالزعامات والجماعات كالاحزاب. فلبنان كان الساحة التي استباحتها كافة الأطراف الخارجية، بدءاً بدولة الاحتلال الأخيرة في العالم، أي إسرائيل، مروراً بالقوى الغربية وصولاً الى الانظمة الشقيقة والصديقة متعددة التوجه والقرب او البعد الجغرافي أو أحزاب عقائدية او جهات ومجموعات إرهابية أصولية. وكما نعلم ليس للاغتيال كرقابة وقمع سوى رسالة واحدة: ممارسة الإرهاب من أجل القضاء على أي مقاومة أو صوت أو معتقد مختلف.. أو أي صوت حرّ.
وإذا كان من غير الممكن القضاء على إرهاب الدولة الإسرائيلية المحتلة إلا بالقضاء على الاحتلال وبإحلال السلم الحقيقي، يظل بإمكاننا ومن واجبنا مواجهة الاغتيالات المحلية الطابع والتي تمارس من جميع الأفرقاء الآخرين سواء أكانوا أشقاء أم قوى أقليمية ومخابراتية مختلفة، والتي تهدف الى إسكات الصوت الآخر المختلف والقضاء على أي معارضة سياسية.
من هنا يبدو أن وضع نسق معين للاغتيال ليس سهلاً ولكنه نوع من تمرين يسهّل محاولة الفهم ليس إلا. فعدا عن الاغتيالات المباشرة وغير المباشرة التي نفذتها اسرائيل والتي لن نتوسع فيها لأنها تصنف ضمن الإرهاب الإسرائيلي الممارس من قبل دولة محتلة والمدان حكماً. لكن سوف نحاول تضمين الاغتيالات الاخرى التي لم يكن واضحاً فيها العامل الاسرائيلي أو أنه لم يتأكد لأن "ظلم ذوي القربى أشد مضاضة".
يصعب تحديد صفة واحدة للاغتيال فهو مصطلح يستعمل لوصف عملية قتل منظمة ومتعمدة تستهدف شخصية مهمة أو قيادية ذات تأثير فكري أو سياسي أو عسكري وتكون أسباب عملية الاغتيال عادة إما عقائدية أو سياسية أو إقتصادية أو إنتقامية تستهدف شخصا معينا يعتبره منظموا عملية الاغتيال عائقا في طريق إنتشار أوسع لأفكارهم أو أهدافهم .
لسنا في صدد مراجعة كاملة وتصنيف للاغتالات العديدة التي حصلت في لبنان، لكن ما نقوم به هو نوع من المساعدة على فهم انواع الاغتيال مما يساهم ربما في تلمس بعض الأسباب المؤدية له وتدخل فيها جميع عوامل الانتقام والتحذير والترهيب والقمع. على كل حال نجحت موجة الاغتيالات التي حصلت في الثمانينات في فرض نوع من الرقابة الذاتية طالت الصحف والنشرات الاخبارية والتلفزيونات والحياة السياسية عامة وجميع أشكال التعبير والتواصل. وربما كانت هذه الرقابة الذاتية أحد الأهداف الأساسية المضمرة لهذه الاغتيالات وهي قد نجحت في الوصول الى غايتها لأنها كما نعلم كونها مموهة وتغيّب أي اعتراض علني تجعل الأمور تبدو طبيعية فتكون أقوى وأفعل من الرقابات الأخرى . وتوفر على من يقوم بها صفة القمع والاستبداد موحية بوجود حريات عامة وحرية تعبير ..
اغتيال "وطني" بمعنى محلي وتمرين العنف الأول
شكّل اغتيال نسيب المتني ، نقيب المحررين السابق، صاحب ورئيس تحرير اليومية المعارضة "التلغراف" والمعروف بانتقاداته الحادة لسياسة الرئيس شمعون الخارجية وللفساد في عهده ، فاتحة الاغتيالات السياسية لصحافي بعد الاستقلال. كان اغتيال المتني عام 1958 «صُنع في لبنان» مئة في المئة، على عكس الاغتيالات اللاحقة. دفع المتني دمه ثمناً لموقفه السياسي وبسبب معارضته لسياسات الرئيس. فلقد وقف بكل ما أوتي من قوة ضد التجديد لرئيس الجمهورية، معتبراً ان «التمديد جريمة»، ومعلناً معارضته "الاعتداء على الدستور... وفرض شخص لمدة 12 سنة، حتى لو كان أقرب أقربائنا وأعز أصدقائنا" .
شكل اغتياله الشرارة التي أطلقت موجة عنف في اليوم التالي لاغتياله، فدعت المعارضة الى الاضراب العام وفي يوم التشييع انطلقت تظاهرات عارمة في عكار والمنية والشوف والبقاع وصيدا، عبرت عن الغضب والاستنكار تجاه الاحلاف العسكرية الاجنبية وطالبت باستقالة شمعون. وفي طرابلس اشتبك انصار رشيد كرامي مع الجيش وفي بيروت الغربية ظهرت المتاريس في الشوارع. لـ «يُدشّن» باغتياله عهد جديد من «ترهيب» قادة الرأي. وكان ذلك بداية ما عرف بأحداث العام 1958.
الاغتيال ذو الطابع الاقليمي
جاء اغتيال كامل مروة بعد ذلك بعدة سنوات ليدشن حقبة الاغتيال لمصلحة جهات خارجية. تكمن أهمية كامل مروة في مساهمته الفاعلة في تطوير الصحافة اللبنانية، إخراجاً وإنتاجاً وتحريراً. فإلى ابتكاره الافتتاحية القصيرة، في زمن المطوّلات أو المعلقات الصحافية، أدخل المكننة الى دنيا الصحافة في لبنان والعالم العربي، فلقّب بأبي الصحافة العربية الحديثة.
أما في السياسة، فلم ينجذب الى الأفكار الثورية والاشتراكية التي سادت خلال الخمسينات والستينات من القرن المنصرم، في عدد من الدول العربية. بل عارضها بشدة عبر افتتاحياته التي كان يتابعها صانعو القرار في الوطن العربي بانتظام. لكن المعارضة السلمية لم تكن مقبولة – ولا تزال- في الوقت الذي استتبت فيه السلطات في عدد من الانظمة العربية عن طريق الانقلابات العسكرية. وجاء في سياق الحديث عن قليلات الذي قيل انه المحرض على الاغتيال "أن الحياة كانت أداة بارزة في خدمة سياسات الدول الغربية.. وانها تحولت الى مؤسسة ضخمة بفعل أموال السعودية" !! وكأننا في بلاد تجترّ نفسها وتستعيد كلشيهاتها دون كلل ... اما مروة فكان قد كتب في افتتاحية جريدة الحياة عام 1965:"إن معاملة المواطنين كشعب محتل، لا قول له ولا رأي ولا حرية، ليست من مقومات البقاء ولا من دلائل العافية». وربما مثل هذه الممارسات هي التي ساهمت في تدهور فكرة العروبة وتأزمها.
اغتيل مروّة بعد عشرين عاماً من نضال صحافي على صفحات «الحياة»، والقلم في يده، كاتباً افتتاحية السابع عشر من أيار 1966، والتي لم تكتمل. فصدر عدد ذلك اليوم من الصحيفة وعلى صفحتها الأولى خبر وحيد وحزين: «اغتيال كامل مروّة في مكتبه".
وهو نموذج للاغتيال ذو الطابع الاقليمي لأن الكثير من تلك التي حصلت في لبنان كان لها هذا الطابع مع اغتيال المناضل موسى شعيب واغتيال كمال جنبلاط او اختفاء الامام موسى الصدر واغتيال المفتي حسن خالد وصولاً الى ما بعد انتفاضة 14 آذار والتي طالت سياسيين وصحافيين. وآخر اغتيال من هذا النوع حتى الآن كان عماد مغنية أبرز قادة حزب الله العسكريين في دمشق . ولقد اتهم الحزب إسرائيل بهذا الاغتيال.
حقبة اغتيالات القمع والارهاب الفكريين والعقائديين
أما أكثر الاغتيالات تجسيداً للدور النضالي والفعل المقاوم الذي يقوم به الصحافي فتؤكدها الطريقة فائقة الوحشية التي تمت فيها تصفية سليم اللوزي في 4 آذار 1980 والتي شكلت رسالة إرهاب صاعقة لكل من يحذو حذوه. اختطف اللوزي ونقل الى منطقة عاليه ثم وجد جسده في ساعات المساء المتأخرة مرمياً في دغل من الأشجار. في مؤخرة الرأس طلق ناري حطّم الجمجمة ومزّق الدماغ. ذراعه اليمنى مسلوخ لحمها عن عظمها حتى الكوع، والأصابع الخمس سوداء نتيجة التذويب بالأسيد أو حامض الكبريت بينما لسانه مقطوعا من جذوره وكان رأسه مفجراً برصاصة اخترقته من جانب الى الآخر و كانت اذناه مصلومتين وعيناه مفقوءتين. كما عثر على أقلام الحبر مغروزة بعنف داخل أحشائه من الخلف... في مشهد تعذيب ساديّ شديد التعبير عن الغاية من القتل. الانتقام من فعل الكتابة نفسه ومن كل من يرى ويسمع وينطق.
أما السبب فلأنه ذو لسان جريء، وقلم لاذع، ورأي صادم غير مهادن. الذنب الذي اقترفه سليم اللوزي الذي اعتقد انه غدا بعيداً وبأمان في العاصمة البريطانية التي عاد منها ليومين من اجل المشاركة في جنازة والدته كان اصداره "الحوادث" في اسبوعين متلاحقين بغلافين مثيرين واستفزازيين الأول هو "عقدة العقيد"، والثاني هو "عندما يكذب النظام". ولطالما ناضل اللوزي بالكلمة من أجل إيصال الحقيقة والدفاع عنها وتعرض للملاحقة والطرد من أكثر من بلد عربي. ولكن يبدو أن عناده الذي لا يشبهه فيه الا عناد جبران التويني، آخر شهداء الصحافة، هو ما جعله يطمئن الى الضمانات التي حصل عليها قبل ان يعود الى لبنان تلك العودة الاخيرة .. وتبين انه لم يكن على حق بتكراره بانه اقوى من الخطف واقوى من القتل، لأن هيبة الكلمة برأيه، هي أقوى من هيبة المسدس. ولقد خدم اغتياله في ترسيخ القمع والخوف في نفوس الصحافيين المقاومين للتسلط والقمع.
أما رياض طه الذي سبق وتعرض للاغتيال في العام 1947 بسبب مقالاته ضد الاقطاعية والاجرام وبيع الوظائف والسمسرة والاثراء غير المشروع، فكان قد نشر مقالا عنيفا بعنوان "خصمي وحاكمي" الذي كان كافيا لأن يصدر قرارا من مجلس الوزراء بتعطيل الصحيفة الى أجل غير مسمى. كما جرت محاولة فاشلة اخرى لاغتياله في العام 1952، وقد تبنت نقابة الصحافة المقال الذي سبب الاعتداء. ونشرته سائر الصحف لتردع الزعماء الذين يلجأون الى هذا الاسلوب في الرد على الصحافيين.
ولقد تم اغتيال رياض طه نقيب الصحافة اللبنانية في 23 تموز 1980، وبعد 4 أشهر تقريبا على اغتيال سليم اللوزي، عندما اعترض سيارته مسلحون يستقلون ثلاث سيارات في منطقة الروشة في بيروت، وأطلقوا النار عليه وفروا الى جهة مجهولة . كان رياض طه يكتب عن التجاوزات السورية والفلسطينية ايضا. وكان يحاول تقريب وجهات النظر بين العراق والكويت وسوريا والعراق وبين الأفرقاء اللبنانيين. كما ربط بين اغتياله والحرب العراقية – الايرانية من بين اغتيالات اخرى: عبد الوهاب الكيالي، موسى شعيب.. وتعد هذه السيرة بامتياز سيرة "مقاوم" وطني لبناني ومدافع عن حرية التعبير في إطار سلطة الدولة الوطنية.
ويدخل في هذه الفئة عدد من الاغتيالات في أعوام الثمانينيات وطالت عدداً من المفكرين متنوعي التوجهات منهم: الشيخ الدكتور صبحي الصالح 1927 – 1986. كما عرفت بعض الاغتيالات ذات الطابع العقائدي وهي تدخل في سياق القمع والقضاء على الشبيه الذي يسبب الخوف لأنه يحمل صورتنا الى اقصاها، من هنا ضرورة القضاء عليه. ونموذج هذا الاغتيال المفكر حسين مروة (1908- 1987)، الشيخ المرتد شكل ايضا نموذجا مسيئاً ومخيفا وحاملا للضرر، من هنا ربما اغتياله. أيضاً يدخل اغتيال حسن حمدان (1936- 1987) في هذا السياق، فمهدي عامل الشيوعي الملحد الذي ذهب بخياره الى الحد الذي شكل تحديا حقيقيا ومنافسة لمن كانوا معه على نفس الخط وتحوّلوا الى نقيضه فتم القضاء عليه. وهي امثلة تشكل عالى كل حال تحذيرا للآخرين أن انتبهوا ما سوف يصيبكم اذا ما فعلتم بالمثل. ولقد نجح هذا الترويع لفترة كافية. اختتمت الثمانينيات مع اغتيال المفتي الشيخ حسن خالد1921- 1989.
خفت عمليات الاغتيال في التسعينات وفيما عدا اغتيال مصطفى جحا الذي أزعج الكثيرين في كتاباته ، مما تمخض عن فتوى تكفيرية صدرت عن المحكمة الجعفرية تمّ تعميمها ونشرها في كافة المحاكم الإسلامية والمرجعيات. تعرض مصطفى جحا لعملية الاغتيال التي أودت بحياته في منطقة الجديدة حيث تم إطلاق النار عليه من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة .
ولقد اختفت الاغتيالات بعد أن استتبت الرقابة الذاتية في أحسن وأنجح حالاتها على الاطلاق، على مستوى الصحافة وقادة الرأي والسياسيين والنخب الحاكمة، فيما عدا قلائل همّشوا عن جنة المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.وعادت الى الظهور انطلاقا من العام 2002 مع اغتيال ايلي حبيقة ذو الطابع الملغز ومتعدد الأسباب. ومن ثم رمزي عيراني في استعادة للقمع والترهيب


 الصفحات
الصفحات سياسة
سياسة




















